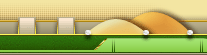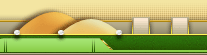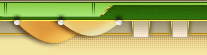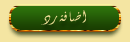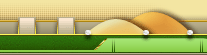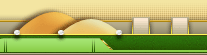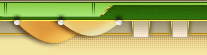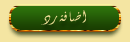بين ذاكرتين
كنتُ في السابعة من عمري راعياً لغنيماتي التسع، أرعاها في شعف قريتنا المطل على تهامة، وكنت ضمن رعاة القرية الذين يرصون الطريق الترابي ما بين أبها والطائف. بالطبع لم يكن معبداً حينها، وكان مرور السيارات قليلاً جداً، بالكاد تمر سيارتان في الشهر، وكانت من النوع المرسيدس التي نطلق عليها (الحمالي). ذات يوم والسكون يلف الشعف الذي نرعى فيه، سمعنا صوت سيارة على بعد ثلاثين كم أو يزيد، نعرف مسبقاً بأنها ستمر علينا بعد ساعة تقريباً وذلك لوعورة الطريق، فرحنا نستعد لمرورها بحصر مواشينا بعيداً عن الطريق وكأن حدثاً فريداً من نوعه سيحصل. بعضنا عبر أحلامه من خلال تصورها، والآخر لم ير سيارة في حياته.
أصَخْنَا أسماعنا فيما صوت كوابح السيارة يرتفع تارة وينخفض، ولكنه بالمجمل في تصاعد مستمر نحونا. كنا متعطشين لرؤيتها وكنت أرى ذلك خصوصاً في عيون الفتيات اللاتي كن يرعين معنا. فجأة صرخت إحداهن: السيارة.. السيارة.. فنظرنا جميعاً فإذا هي آتية. اندهشنا وأخذنا نراقبها ونتأملها ونحن في دهشة من عظمتها وحجمها، كما أن لصوت محركها نغم جميل. أما رائحة الديزل فمازالت مخزنة تحت أنفي الذي تضخم بفعل السنين.
فجأة وقفت تلك السيارة وترجل منها سائقها الذي كان في غاية الضخامة مما أسبغه هيبة وخوفاً منا. فصاح علينا: عودوا من حيث أتيتم أيها الجهلة. وكان يحمل صندوقاً بين يديه، فنظرنا في بعضنا ولسان حالنا يقول لن نترك هذا الغريب يفرض رأيه علينا. لنذهب إلى ذلك الرجل ونعرف ماذا لديه. مشينا نحوه كصف وبخطوة ثابتة تقدمنا نحوه. فأخذ من الصندوق شيئاً أصفر أشبه ما يكون بالكرة الصغيرة ورماه تجاهنا، فأمسكت به إحدى الفتيات وهي أكبرنا، فاجتمعنا عليها لنتفحص هذا الشيء. كانت رائحتها زكية وعبيرها نفاذاً. وما إن رأى البهجة على وجوهنا حتى رمى ما في بقية الصندوق علينا وهو يضحك ويقول: هذا برتكان قشروه قبل الأكل. ولكننا لم نكن نستوعب تقشير فاكهة البرتقال فقمنا بالتهامه بقشرته المرة، ولأن الغنم سرحت عنا بعيداً وعاثت في مزارع القرية بينما كنا ننعم بأكل البرتقال، فقد كانت ليلة قاسية، إذ تم عقاب الجميع بالعصا قبل دخول القرية. غير أنني أعترف أن البرتقال هو من انتصر، فقد بقيت رائحته عالقة في الذاكرة وتحت أظافر أيدينا التي تنفخت بفعل الضرب والرعي وقساوة الأيام. تلك الأيام التي توالت في ضرباتها فحملت إلينا رائحة رأس خروف عيد الأضحى الذي أولم به في القرية شيخها الكبير حيث (شعوط) رأس الخروف بعناية، وقد كانت رائحة تلك الشعوطة بمثابة بطاقة دعوة مجانية لكافة سكان القرى، والتي مهما تفنن المضيّف في إخفاء تلك الرائحة الساحرة إلا أنَّ أهل القرية يملكون حاسة شم فلكية تنافس الذئب وأبي الحصين في قوتها. كان ذلك في عيد الحج من عام 1390هـ، حين تناهى إلى أسماعنا وجود ضيف حكومي كبير سيزور النماص قريباً. الجميع بدأ يتخيل هذا الضيف الكبير. بالنسبة لي تخيلته كبيراً في الجسم، وبدأت أقارنه بأكبر شيء في قريتنا فلم أجد أكبر من الحصن، ومع الوقت تحول هذا الزائر إلى حصن في مخيلتي. مرت الأيام ونحن لا ننفك عن تخيل هذا الزائر العظيم حتى جاء يوم زيارته وقد صادفت يوم العيد. مما دفع الشيخ إلى دعوة القرية بأكملها إلى مأدبة غداء عامة، فزاد اللّغط وكثرت الإشاعات عن عدد تلك الذبائح التي سيتم تقليطها في هذا الغداء الحلم، وقد تم نحر جمل إلى جانب الخراف فكثر الهرج والمرج وذلك لندرة الجمال عندنا. بدأت أعد العدة وأستعد لذلك اليوم العظيم وكان يوم ثلاثاء، تحركنا صباحاً من قريتنا القريبة من بيت الشيخ إلى النماص تحديداً. الوجهاء وكبار القوم يمتطون ظهور الحمير والبقية راجلون وأغلبهم حفاة القدمين. وكان هذا حال جميع القرى المحيطة بالنماص، تجمع القوم وكان هناك حفل كبير على شرف الضيف الذي لم يعد يهمني قدر اهتمامي بما سأملأ به بطني المجوعة منذ أيام. تفنن شباب القرية في أداء العرضة ولمعت قريحة الشعراء بأفضل ما لديهم. ومن ثم تحرك الجميع إلى مأدبة الغداء العظمى التي كان طولها خمسين متراً، وخلال ثوان معدودة تم ملء كل الفراغات. كلٌ وذراعه ومن لديه ابن جذبه إلى جانبه. خرجت أصوات الأضراس وهي تمضغ اللحم، والأفواه وهي تتذوق طعمه. أما أنا فمازلت أبحث عن فراغ أنحشر فيه. كنت أرنو إلى بعض الرجال الذين يعرفونني لعلهم يشفعون لي، فجسمي الصغير لا يحتاج إلى أكثر من شبر. لكن الجوع والشراهة أعمت بصرهم عني وربما أنكروني. ولأن والدي وقتها كان في الرياض، فأنا أشبه باليتيم. أثناء الشوط الثالث من السعي بين طرفي المأدبة لمحت أحد الأطفال تحرك من مكانه فهبطت كالنسر الكاسر في الفراغ الذي تركه. لكن نظرة أبيه لي كانت هي الأوجع. فلو وجهت لحجر لفلقته. لقد أصر على عودة ابنه الذي شبع إلى مكانه. لكنني لم أبتئس فقد وجدت نفسي أجرش الطعام ونسيت أهو جمل أو حتى ديناصور. أكلت حتى سال العرق من جبيني ونلت مأربي، وبَقِيَت في ذاكرتي رائحة البرتقال التي أصبتها وشعوطة رأس الخروف الذي لم أصبه وعلمت معنى (ويل للأيتام على موائد اللئام).
المجلة العربية :: إبداع
عاطف بن لشول: الرياض